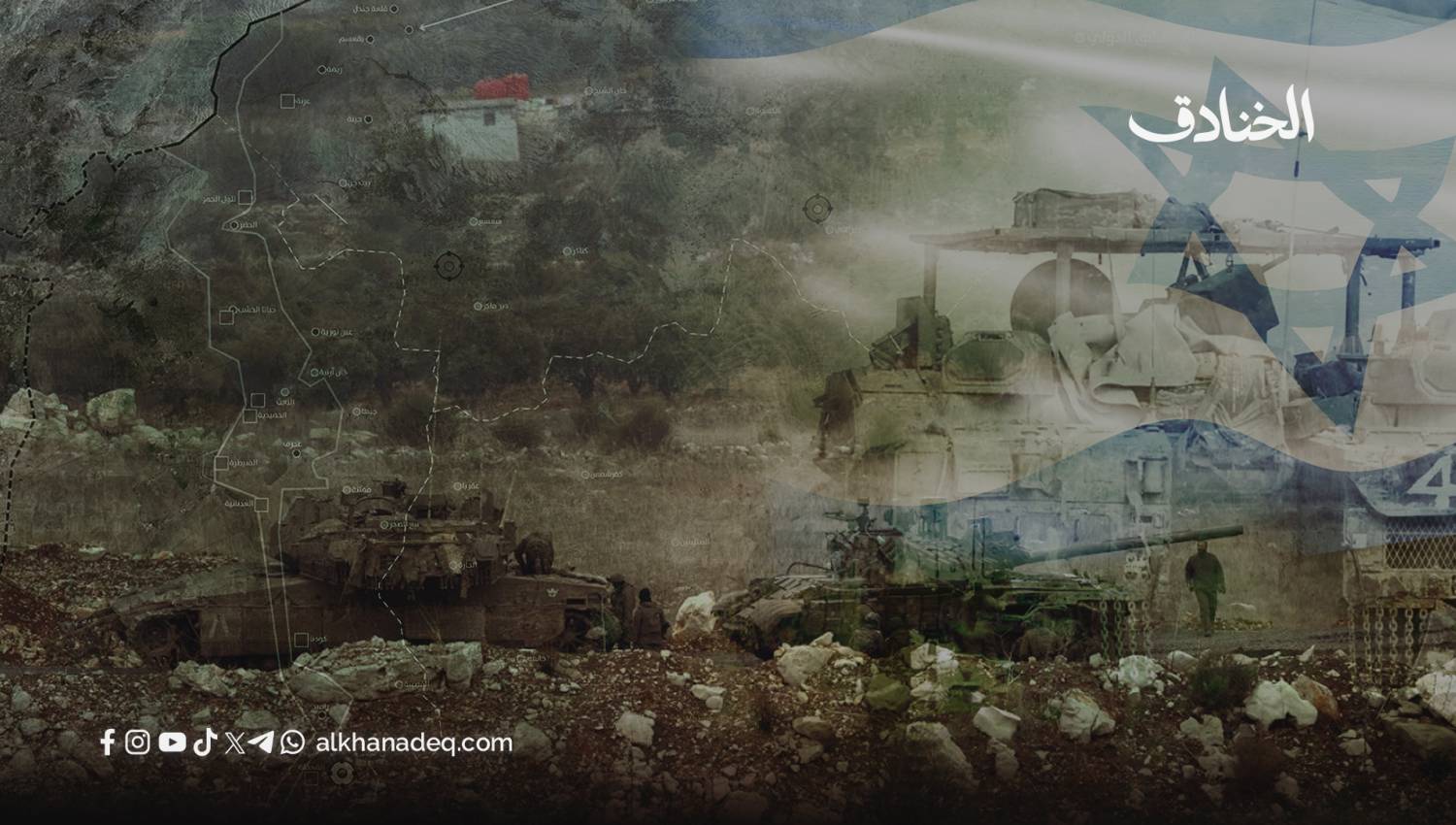
في منطقة الشرق الأوسط، لم تعد المياه مجرّد مورد طبيعي للحياة، بل أصبحت أداة للسيطرة والابتزاز ومحرّكاً للصراعات. فبينما تمثّل ندرة المياه أزمة بيئية وإنسانية في ظاهرها، تكشف الوقائع الميدانية والسياسات الدولية أنّها تُستخدم كسلاح استراتيجي لتغيير الجغرافيا السياسية وإعادة رسم خرائط النفوذ.
برز هذا التحوّل بوضوح في جنوب سوريا، حيث سيطر الكيان الإسرائيلي أواخر عام 2024 ومطلع 2025 على أربعة سدود رئيسية في محافظة القنيطرة – أبرزها سد المنطرة، أكبر خزّان مائي في الجنوب – وحوّلها إلى نقاط عسكرية مغلقة، مانعاً الأهالي من استخدامها في الزراعة أو الشرب. تهدف هذه الخطوة إلى تجفيف موارد الحياة ودفع السكان إلى النزوح، في إطار سياسة تهجير ممنهجة تعيد إلى الأذهان تجربة الجولان المحتل. وقد شكّلت السيطرة على المياه أحد أدوات الاحتلال في فرض واقع ديموغرافي جديد، يضمن له الهيمنة على الأرض والحدود والموارد.
يتقاطع هذا السلوك مع الرؤية الأمريكية الأشمل التي ترى في أزمة المياه فرصة لبناء نفوذ أمني وعسكري مستدام. فبحسب ورقة صادرة عن مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية التابع لقيادة الجيش الأمريكي، يجري التعامل مع ندرة المياه في الشرق الأوسط باعتبارها "تهديداً ثلاثي الأبعاد" – محفزاً للعنف، وسلاحاً في النزاعات، وضحية للحروب. لكن القراءة المتعمقة تكشف أن الهدف الحقيقي هو تحويل هذه الأزمة إلى أداة لتوسيع النفوذ الأمريكي عبر تبرير التدخل العسكري، وتطويق الخصوم، وتعزيز شبكات الاعتماد الأمني على واشنطن.
تقوم المقاربة الأمريكية على ثلاث ركائز أساسية: أولها تحويل المساعدات إلى وسيلة للهيمنة الأمنية، من خلال برامج تسليح وتدريب تهدف إلى وضع البنية التحتية المائية تحت المراقبة الأمريكية بذريعة حمايتها من الإرهاب أو الفوضى. وثانيها استغلال الضعف الداخلي للخصوم، خصوصاً إيران، عبر عمليات معلوماتية تروّج لروايات الفساد وسوء الإدارة في قطاع المياه لتقويض شرعية النظام من الداخل. أما الركيزة الثالثة فهي إعادة تعريف الأمن المائي كأمن عسكري، بحيث تصبح القيادة المركزية الأمريكية اللاعب الرئيسي في إدارة الموارد، وليس المؤسسات الإقليمية أو الوطنية.
تؤكد الوقائع أن هذا التوظيف السياسي للمياه ليس جديداً. فمنذ خمسينيات القرن الماضي، شكّلت السيطرة على مصادر المياه أحد دوافع الحروب العربية الإسرائيلية، كما حدث في "معركة المياه" بين إسرائيل وسوريا في ستينيات القرن الماضي. واليوم، يتجدد المشهد في ملفات أخرى، أبرزها النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سدّ النهضة، الذي يهدد أمن مصر المائي ويعيد فكرة "حروب المياه؟" إلى واجهة التوترات الإقليمية. فالمياه لم تعد سبباً ثانوياً للصراع، بل أصبحت عنصراً مركزياً يحدّد بقاء الدول واستقرارها.
وفي إيران، تحوّلت أزمة الجفاف إلى عامل اضطراب داخلي يهدّد الاستقرار السياسي. فقد شهدت مناطق خوزستان وأصفهان وسيستان احتجاجات حادة بسبب نقص المياه وانقطاع الكهرباء، ما دفع الحكومة إلى فرض إجراءات تقنين قاسية. غير أن واشنطن ترى في هذه الأزمة فرصة لتأجيج السخط الشعبي واستثمار الغضب لتقويض النظام، وفقاً لما تشير إليه الوثائق الأمريكية نفسها.
إلى جانب الاستخدام السياسي، تحوّلت المياه في النزاعات الحديثة إلى سلاح مباشر. فقد استخدم تنظيم "داعش" السيطرة على سدود العراق عام 2014 كورقة ضغط ضد المدن والمناطق المجاورة، وهدد بإغراق بغداد عبر تفجير سد الموصل. وتكررت الظاهرة في نزاعات أخرى كالهند وباكستان حول نهر السند، حيث أوقفت نيودلهي التعاون في معاهدة تقاسم المياه، ما جعل الماء أداة عقاب واستنزاف اقتصادي للخصم.
إن تحوّل المياه إلى أداة حربية يحمل أبعاداً إنسانية خطيرة، إذ تصبح الموارد المائية نفسها ضحية للعمليات العسكرية، وتتحول محطات الضخ والسدود إلى أهداف مباشرة. ويؤدي ذلك إلى انهيار أنظمة الزراعة والصرف الصحي، ويزيد من تفكك المجتمعات الهشة. ووفقاً لنظرية ماسلو للحاجات الإنسانية، فإن الحرمان من المياه، وهي من أساسيات البقاء، يدفع المجتمعات نحو العنف والصراع من أجل الوجود.
تؤثر أزمة المياه كذلك في العمليات العسكرية نفسها، إذ تفرض تحديات لوجستية وصحية على الجيوش العاملة في مناطق الجفاف، وتجعل خطوط الإمداد أكثر هشاشة، ما يفتح الباب أمام أعداء الولايات المتحدة لاستهدافها في نقاط الضعف. لذلك تدعو الدراسات الأمريكية إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي وتطوير أنظمة مراقبة متقدمة لحماية "الأمن المائي"، وهو ما يعني عملياً عسكرة إدارة المياه في المنطقة.
وفي المحصلة، لم تعد المياه في الشرق الأوسط قضية بيئية أو تنموية فحسب، بل أضحت عنصراً محورياً في المعادلة الجيوسياسية. فالكيان الإسرائيلي يستخدمها لفرض التهجير والسيطرة الميدانية، والولايات المتحدة توظفها لبناء منظومة نفوذ عسكري طويل الأمد، فيما تتصارع الدول العربية والإقليمية على ما تبقّى من أنهارها وسدودها. في ظل هذه المعادلة، يصبح الأمن المائي مرادفاً للأمن القومي، وتغدو إدارة الموارد مسألة سيادة وبقاء لا تقل أهمية عن حدود الأرض أو قوة السلاح.
الكاتب: غرفة التحرير